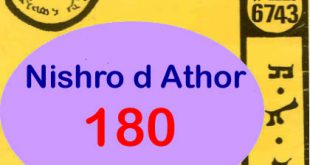وهذا القبول في واقع الأمر يعبر عن تطلع حقيقي نحو التغيير يراود جميع المواطنين في سوريا. لهذا فإنه مع إعلان الرئيس بشار الأسد في اجتماع القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية في بداية آب الماضي عن قرب تغيير الحكومة، وجعل الإصلاح الإداري في مقدم مهام الحكومة الجديدة. علّق المواطنون آمالاً كبيرة على تشكيل حكومة جديدة تتحلى بإرادة وقدرة على تقليل معاناة الناس وتخطي مشاكلهم الاقتصادية المتزايدة، ووضع حد للفساد المستشري في أكثر من مكان.
وخلال الفترة الزمنية التي سبقت استقالة حكومة السيد محمد مصطفى ميرو. راجت توقعات كثيرة حول التشكيل الوزاري المرتقب، وطبيعة التغيير الذي سيطال بنية الحكومة من دمج لبعض الوزارات وإلغاء لبعض الحقائب ومواصفات وأسماء من سيشغلون الحقائب الباقية بشكل ينسجم وطبيعة المهام المرسومة للحكومة. وبالغ البعض في توقعاته بأن تنبأ بتكليف شخصية من خارج القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، مستنداً فيما ذهب إليه على القرار 408 للقيادة القطرية لحزب البعث القاضي بحصر دور الحزب في التخطيط والإشراف والرقابة والمحاسبة. لا بل أن البعض شطح به الخيال إلى حد توقع تولي الرئيس بشار نفسه رئاسة الحكومة لإعطاء زخم أقوى لتطبيق نهج الإصلاح الذي دعا إليه منذ خطاب القسم. وفي هذه المرحلة أيضاً تصاعدت وتيرة الضغوط الأميركية على سوريا، وسربت الإدارة الأميركية تحذيرات حول تشدد بعض المسؤولين السوريين في محاولة تهدف إلى التشويش والتأثير في قرار تشكيل الحكومة. لكن جاء قرار تكليف السيد محمد ناجي العطري رئيس مجلس الشعب بتشكيل الحكومة الجديدة ليؤكد صواب أصحاب النظرة الواقعية المدركة لدقائق الحياة السياسية وتفاصيلها في سوريا بعيداً عن التوقعات والتمنيات المفرطة في تفاؤلها والمتطلعة إلى تغيير جذري لن يحصل بين ليلة وضحاها. وحقيقةً لم يعول الكثير من المواطنين على تغيير جذري، ولا يوجد في سوريا من يراهن على تغيير جذري يطيح بكل ما هو قائم، لا بل على العكس فإن الجميع يتطلع لتغيير تدريجي انطلاقاً مما هو قائم لكن بوتائر أسرع، وبشكل أكثر جرأة، لإعطاء شيء من الثقة والمصداقية بجدوى وأهمية الإصلاح والتغيير الذي يتم.
وبالعودة إلى الفريق الوزاري الذي شكله السيد محمد ناجي العطري نجد أنه لم يحمل جديداً، وإنما جاء نسخة معدلة عن الفريق الذي سبقه. فالعطري نفسه جاء من نادي القيادة القطرية الذي خرج منه معظم رؤساء الحكومات السابقين. واحتفظ حزب البعث بـ 17 حقيبة أساسية معززة بتمثيل بعثي أقوى من السابق، يشغل عديد من هذه الوزارات أربع أعضاء من القيادة القطرية، وثلاث أعضاء من اللجنة المركزية، وعضو قيادة قومية احتياط. علاوةً على ذلك فإن القيادة القطرية هي التي اختارت المستقلين وممثلي أحزاب الجبهة، وأبقت خمسة منهم دون حقائب.
كما أن الدمج المحدود للوزارات لم يحدث بشكل يوحي بأن الإصلاح يتجه نحو الأهداف المنشودة، إضافة إلى أن إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء جاء خالياً من المضمون باعتبار أن نواب الرئيس في الحكومة السابقة، بقوا في الحكومة الحالية مع احتفاظهم بحقائب هامة. وفوق هذا وذاك فإنه يجري تداول أحاديث مفادها أن التشكيلة الوزارية الجديدة جاءت للتأكيد على أن القيادة السياسية في سوريا لا تخضع للضغوط الخارجية، والبعض يزعم أن التغيير الحقيقي لن يتم قبل انعقاد المؤتمر القطري لحزب البعث بعد حوالي سنتين وهذا يعني وضع عملية الإصلاح برمتها في ثلاجة الانتظار. وأن مهمة الحكومة الجديدة هي قتل الوقت، والقيام بتصريف الأعمال لكن بوجوه جديدة. على اعتبار أن الحكومة السابقة افتقدت حتى القدرة على تصريف الأعمال. لهذا فإن شكوكاً كثيرة تحوم حول قدرة الحكومة الجديدة على القيام بالإصلاح الإداري والاقتصادي باعتباره يحتل قائمة الأولويات. لأن الإصلاح مهما بدا صغيراً لا يمكن أن تقوم به جهة واحدة. حيث لا يمكن القيام بالإصلاح الإداري واقتلاع شأفة الفساد في ظل سيادة منطق الاحتكار والاستئثار بكل شيء. في حين أن ذلك يحتاج إلى الانفتاح، وتعميق القناعة بضرورة مشاركة كل شرائح المجتمع والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات العامة للبلد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. ولا يمكن أن يتخذ الإصلاح مساره الفعلي من خلال عمليات تجميلية أو إحلال أشخاص مكان آخرين يحملون نفس الفكر، ويستخدمون الآليات ذاتها في معالجة القضايا المجتمعية كبيرة كانت أم صغيرة. وباعتبار أن الإصلاح على مختلف أشكاله يمثل ضرورة نابعة من الحاجات الوطنية، وعملية تراكمية مستمرة لا تنتظر التأجيل، لهذا لا يجوز ربطه باستحقاقات وظروف هذا الحزب أو ذاك، أو بالأوضاع الإقليمية والضغوط الخارجية وسواها من الذرائع التي في حال تم الركون إليها من شأنها أن تجهض العملية الإصلاحية برمتها.
لا شك أن أهم ما تمخض عن مقولة التطوير والتحديث التي دعا إليها الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم هو إطلاق حرية القول والتعبير لدى معظم شرائح المجتمع في سوريا. وجعل كل مواطن شريكاً في عملية الإصلاح التي يفترض أن تتوجه إليه بالدرجة الأولى. لكن لا يمكن تقييد عملية الإصلاح بمسارات محددة دون سواها، فالعملية لا يمكن تجزئتها، إذ لا بد من أن تكون متكاملة وشاملة حتى تبلغ الغايات المرجوة منها. من هنا تبدو الحاجة ملحة لإجراء إصلاحات سياسية دونما تباطؤ، لأن الإصلاح السياسي هو الحاضن الفعلي الذي يوفر المناخ لأية إصلاحات أخرى. وأي تأجيل أو تأخير في عملية الإصلاح السياسي تجعل من الإصلاحات الأخرى ناقصة ومشوهة.
وعليه فإن التحدي الحقيقي أمام الحكومة الجديدة التي نأمل نجاحها هو قدرتها على القيام بإجراء إصلاحات حقيقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، ولا يمكن أن تنجح دون توسيع صلاحياتها، ومدها بالإرادة السياسية اللازمة لإجراء إصلاحات جدية تفضي إلى تعميق الممارسة الديمقراطية، وتوسيع نطاق المشاركة، وإقرار التعددية السياسية والقومية في الحياة العامة، من خلال إصدار قانون عصري للأحزاب والمطبوعات. وكذلك احترام حقوق الإنسان، وبناء دولة القانون والمؤسسات، وتطبيق مبدأ فصل السلطات. عندها فقط يمكن القول أن فرص النجاح متوفرة، لأن العبرة بالصلاحيات وليس بالأشخاص.
 المنظمة الآثورية الديمقراطية ADO
المنظمة الآثورية الديمقراطية ADO